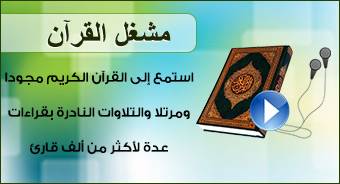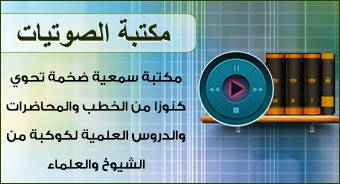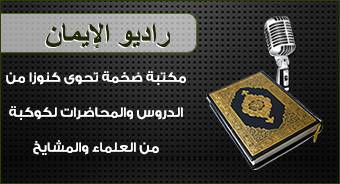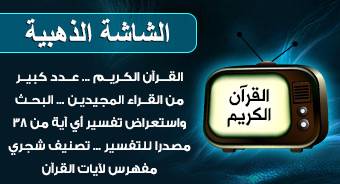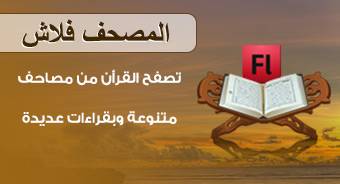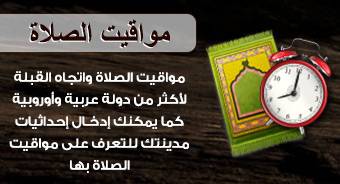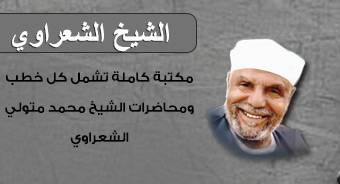|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
الثّانِي: أنّهُ اللّيْلُ كُلُّهُ؛ قال ابْنُ عبّاسٍ: وهُو الّذِي اخْتارهُ مالِكُ بْنُ أنسٍ، وهُو الّذِي يُعْطِيهِ اللّفْظُ، وتقْتضِيهِ اللُّغةُ.المسألة الثّالِثةُ:قوله: {أشدُّ وطْئا}: قرئ بِفتْحِ الْواوِ وإِسْكانِ الطّاءِ فمِمّنْ قرأهُ كذلِك نافِعٌ، وابْنُ كثِيرٍ، والْكُوفِيُّون وقرئ بِكسْرِ الطّاءِ ممْدُودا، ومِمّنْ قرأهُ كذلِك أهْلُ الشّامِ وأبُو عمْرٍو فأمّا منْ قرأهُ بِفتْحِ الْواوِ وإِسْكانِ الطّاءِ فإِنّهُ أشار إلى ثِقلِهِ على النّفْسِ لِسُكُونِها إلى الرّاحةِ فِي اللّيْلِ وغلبةِ النّوْمِ فِيهِ على الْمرْءِ.وأمّا منْ قرأهُ بِكسْرِ الْفاءِ وفتْحِ الْعيْنِ فإِنّهُ مِنْ الْمُواطأةِ وهِي الْمُوافقةُ؛ لِأنّهُ يتوافقُ فِيهِ السّمْعُ لِعدمِ الْأصْواتِ، والْبصرُ لِعدمِ الْمرْئِيّاتِ، والْقلْبُ لِفقْدِ الْخطراتِ.قال مالِكٌ: أقْومُ قِيلا: هُدُوّا مِنْ الْقلْبِ وفراغا لهُ.والْمعْنيانِ فِيهِ صحِيحانِ؛ لِأنّهُ يثْقُلُ على الْعبْدِ وأنّهُ الْمُوافِقُ لِلْقصْدِ.الْآيةُ السّادِسةُ قوله تعالى: {إنّ لك فِي النّهارِ سبْحا طوِيلا} فِيهِ أرْبعُ مسائِل:المسألة الْأُولى:قال أهْلُ اللُّغةِ: معْناهُ اضْطِرابا ومعاشا وتصرُّفا، سبّح يُسبِّحُ: إذا تصرّف واضْطرب، ومِنْهُ سِباحةُ الْماءِ، ومِنْهُ قولهُ: {كُلٌّ فِي فلكٍ يسْبحُون} يُعْنى يجْرُون.وقال: {والسّابِحاتِ سبْحا}؛ قِيل: الْملائِكةُ تُسبِّحُ بيْن السّماءِ والْأرْضِ، أيْ تجْرِي وقِيل: هِي السُّفُنُ: أرْواحُ الْمُؤْمِنِين تخْرُجُ بِسُهُولةٍ.وقال أبُو الْعالِيةِ: معْناهُ فراغا طوِيلا؛ وساعدهُ عليْهِ غيْرُهُ.فأمّا حقِيقةُ (س ب ح) فالتّصرُّفُ والِاضْطِرابُ؛ فأمّا الْفراغُ فإِنّما يعْنِي بِهِ تفرُّغهُ لِأشْغالِهِ وحوائِجِهِ عنْ وظائِف تترتّبُ عليْهِ؛ فأحدُ التّفْسِيريْنِ لفْظِيٌّ والْآخرُ معْنوِيٌّ.المسألة الثّانِيةُ:قرئ {سبْخا} بِالْخاءِ الْمُعْجمةِ، ومعْناهُ راحة وقِيل نوْما.والتّسْبِيخُ: النّوْمُ الشّدِيدُ، يُقال سبّخ، أيْ نام بِالْخاءِ الْمُعْجمةِ، وسبّح بِالْحاءِ الْمُهْملةِ: أيْ تصرّف كما تقدّم.وفِي الْحديث أنّهُ سمِع عائِشة تدْعُو على سارِقٍ، فقال: «لا تُسبِّخِي عنْهُ بِدُعائِك»، أيْ لا تُخفِّفِي عنْهُ، فإِنّ السّارِق أخذ مالها، وهِي أخذتْ مِنْ عِرْضِهِ، فإِذا وقعتْ الْمُقاصّةُ كان تخْفِيفا مِمّا لها عليْهِ مِنْ حقِّ السّرِقةِ.ويُعضِّدُهُ قوله تعالى فِي الْأثرِ: «منْ دعا على منْ ظلمهُ فقدْ انْتصر» وهذِهِ إشارةٌ إلى أنّ اللّيْل عِوضُ النّهارِ، وكذلِك النّهارُ عِوضُ اللّيْلِ كما تقدّم فِي قوله تعالى: {وهُو الّذِي جعل اللّيْل والنّهار خِلْفة لِمنْ أراد أنْ يذّكّر أوْ أراد شُكُورا}المسألة الثّالِثةُ:فِي هذِهِ الْآيةِ تنْبِيهٌ على نوْمِ الْقائِلةِ الّذِي يسْترِيحُ بِهِ الْعبْدُ مِنْ قِيامِ اللّيْلِ فِي الصّلاةِ أوْ فِي الْعِلْمِ.الْمسْألةُ الرّابِعةُ:فِي حالِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذلِك: فقدْ كان يُصلِّي إحْدى عشْرة ركْعة، ورُوِي ثلاث عشْرة ركْعة، يُوتِرُ مِنْها بِخمْسٍ لا يجْلِسُ إلّا فِي آخِرِها.ورُوِي أنّهُ كان يُصلِّي بعْد الْعِشاءِ ركْعتيْنِ، ويُصلِّي مِنْ اللّيْلِ تِسْعا مِنْها الْوِتْرُ، وكان ينامُ أوّل اللّيْلِ، ويُحْيِي آخِرهُ، وما ألْفاهُ السّحرُ إلّا عِنْد أهْلِهِ قائِما وكان يُوتِرُ فِي آخِرِ اللّيْلِ حتّى انتهى وِتْرُهُ إلى السّحرِ، وما قرأ القرآن كُلّهُ قطُّ فِي ليْلةٍ، ولا صلّى ليْلة إلى الصُّبْحِ، وكان إذا فاتهُ قِيامُ اللّيْلِ مِنْ وجعٍ أوْ غيْرِهِ صلّى مِنْ النّهارِ اثْنتيْ عشْرة ركْعة، وكان يقول: «الْوِتْرُ ركْعةٌ مِنْ آخِرِ اللّيْلِ» ويقول: «أوْتِرُوا قبْل أنْ تُصْبِحُوا» وقال «صلاةُ آخِرِ اللّيْلِ مشْهُودةٌ» وذلِك أفْضلُ وهذا كُلُّهُ صحِيحٌ فِي الصّحِيحِ، وقدْ بيّنّا فِي شرْحِ الْحديث الْجمْع بيْن اخْتِلافِ الرِّواياتِ فِي عددِ صلاتِهِ، فإِنّهُ كان يُصلِّي إحْدى عشْرة ركْعة، وهِي كانتْ وظِيفتهُ الدّائِمة، وكان يفْتتِحُ صلاة اللّيْلِ بِركْعتيْنِ خفِيفتيْنِ، فهذِهِ ثلاث عشْرة ركْعة.وكان يُصلِّي إذا طلع الْفجْرُ ركْعتيْنِ، ثُمّ يخْرُجُ إلى صلاةِ الصُّبْحِ، فهذا تأْوِيلُ قول منْ روى أنّهُ كان يُصلِّي خمْس عشْرة ركْعة.وقدْ روتْ عائِشةُ فِي الصّحِيحِ أنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي تِسْع ركعاتٍ فِيها الْوِتْرُ ولعلّ ذلِك كان حِين ضعُف وأسنّ وحطّمهُ الْبأْسُ، أوْ كان لِألمٍ، واللّهُ أعْلمُ.الْآيةُ السّابِعةُ قوله تعالى: {واذْكُرْ اسْم ربِّك وتبتّلْ إليْهِ تبْتِيلا} فِيها مسْألتانِ:المسألة الْأُولى: فِي معْنى التّبتُّلِ:وهُو عِنْد الْعربِ التّفرُّدُ؛ قالهُ ابْنُ عرفة. وقال غيْرُهُ وهُو الْأقْوى: هُو الْقطْعُ، يُقال: بتل إذا قطع، وتبتّل إذا كان الْقطْعُ فِي نفْسِهِ، فلِذلِك قالوا: إنّ معْنى الْآيةِ انْفرِدْ لِلّهِ، وصدقةٌ بتْلةٌ، أيْ مُنْقطِعةٌ مِنْ جمِيعِ الْمالِ.وفِي حديث سعْدٍ: ردّ رسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم على عُثْمان بْنِ مظْعُونٍ التّبتُّل ولوْ أذِن لهُ فِيهِ لاخْتصيْنا يعْنِي الِانْقِطاع عنْ النِّساءِ، وفِي الْأثرِ: لا رهْبانِيّة ولا تبتُّل فِي الْإِسْلامِ، ومِنْهُ مرْيمُ الْعذْراءُ الْبتُولُ، أيْ الّتِي انْقطعتْ عنْ الرِّجالِ، وتُسمّى فاطِمةُ بِنْتُ رسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم الْبتُول، لِانْقِطاعِها عنْ نِساءِ زمانِها فِي الْفضْلِ والدِّينِ والنّسبِ والْحسبِ.وهذا قول أحْدثتْهُ الشِّيعةُ، وإِلّا فقدْ اخْتلف النّاسُ فِي التّفْضِيلِ بيْنها وبيْن عائِشة، وليْستْ مِنْ الْمسائِلِ الْمُهِمّةِ، وكِلْتاهُما مِنْ الدِّينِ والْجلالِ فِي الْغايةِ الْقُصْوى، وربُّك أعْلمُ بِمنْ هُو أفْضلُ وأعْلى.وقدْ أشرْنا إليْهِ فِي كِتابِ الْمُشْكِليْنِ وشرْحِ الصّحِيحيْنِ.المسألة الثّانِيةُ:قدْ تقدّم فِي سُورةِ الْمائِدةِ تفْسِيرُ قوله تعالى: {يأيُّها الّذِين آمنُوا لا تُحرِّمُوا طيِّباتِ ما أحلّ اللّهُ لكُمْ} حالُ الدِّينِ فِي الْكراهِيةِ لِمنْ تبتّل فِيهِ، وانْقطع، وسلك سبِيل الرّهْبانِيّةِ بِما يُغْنِي عنْ إعادتِهِ، وأمّا الْيوْمُ وقدْ مرِجتْ عُهُودُ النّاسِ، وخفّتْ أماناتُهُمْ، واسْتوْلى الْحرامُ على الْحُطامِ، فالْعُزْلةُ خيْرٌ مِنْ الْخُلْطةِ، والْعُزْبةُ أفْضلُ مِنْ التّأهُّلِ، ولكِنّ معْنى الْآيةِ: انْقطع عنْ الْأوْثانِ والْأصْنامِ، وعنْ عِبادةِ غيْرِ اللّهِ؛ وكذلِك قال مُجاهِدٌ: معْناهُ أخْلِصْ لهُ الْعِبادة، ولمْ يُرِدْ انْقطِعْ عنْ النّاسِ والنِّساءِ وهُو اخْتِيارُ الْبُخارِيِّ لِأجْلِ ما رُوِي مِنْ نهْيِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عنْ التّبتُّلِ فصار التّبتُّلُ مأْمُورا بِهِ فِي القرآن، منْهِيّا عنْهُ فِي السُّنّةِ؛ ومُتعلِّقُ الْأمْرِ غيْرُ مُتعلِّقِ النّهْيِ؛ إذْ لا يتناقضانِ، وإِنّما بُعِث النّبِيُّ لِيُبيِّن لِلنّاسِ ما نُزِّل إليْهِمْ، فالتّبتُّلُ الْمأْمُورُ بِهِ الِانْقِطاعُ إلى اللّهِ بِإِخْلاصِ الْعِبادةِ، كما قال: {وما أُمِرُوا إلّا لِيعْبُدُوا اللّه مُخْلِصِين لهُ الدِّين} والتّبتُّلُ الْمنْهِيُّ عنْهُ هُو سُلُوكُ مسْلكِ النّصارى فِي ترْكِ النِّكاحِ والتّرهُّبُ فِي الصّوامِعِ، لكِنْ عِنْد فسادِ الزّمانِ يكُونُ خيْرُ مالِ الْمُسْلِمِ غنما يتْبعُ بِها شعف الْجِبالِ ومواقِع الْقطْرِ يفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتنِ.الْآيةُ الثّامِنةُ قوله تعالى: {واصْبِرْ على ما يقولون واهْجُرْهُمْ هجْرا جمِيلا} فِيها مسْألتانِ:المسألة الْأُولى:هذِهِ الْآيةُ منْسُوخةٌ بِآيةِ الْقِتالِ، وكُلُّ منْسُوخٍ لا فائِدة لِمعْرِفةِ معْناهُ، لاسيما فِي هذا الْموْضِعِ إلّا على الْقول بِأنّ الْمرْء إذا غُلِب بِالْباطِلِ كان لهُ أنْ يفْعل ما فعلهُ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مع الْكُفّارِ حِين غلبُوهُ، وهِي:المسألة الثّانِيةُ:فأمّا الصّبْرُ على ما يقولون فمعْلُومٌ.وأمّا الْهجْرُ الْجمِيلُ فهُو الّذِي لا فُحْش فِيهِ.وقِيل: هُو السّلامُ عليْهِمْ.وبِالْجملة فهُو مُجرّدُ الْإِعْراضِ.الْآيةُ التّاسِعةُ قوله تعالى: {إنّ ربّك يعْلمُ أنّك تقُومُ أدْنى مِنْ ثُلُثيْ اللّيْلِ ونِصْفهُ وثُلُثهُ وطائِفةٌ مِنْ الّذِين معك واللّهُ يُقدِّرُ اللّيْل والنّهار علِم أنْ لنْ تُحْصُوهُ فتاب عليْكُمْ فاقْرءُوا ما تيسّر مِنْ القرآن علِم أنْ سيكُونُ مِنْكُمْ مرْضى وآخرُون يضْرِبُون فِي الْأرْضِ يبْتغُون مِنْ فضْلِ اللّهِ وآخرُون يُقاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ فاقْرءُوا ما تيسّر مِنْهُ وأقِيمُوا الصّلاة وآتُوا الزّكاة وأقْرِضُوا اللّه قرْضا حسنا وما تُقدِّمُوا لِأنْفُسِكُمْ مِنْ خيْرٍ تجِدُوهُ عِنْد اللّهِ هُو خيْرا وأعْظم أجْرا واسْتغْفِرُوا اللّه إنّ اللّه غفُورٌ رحِيمٌ}.فِيها إحْدى عشْرة مسْألة:المسألة الْأُولى:قولهُ: {إنّ ربّك يعْلمُ أنّك تقُومُ أدْنى} الْآية.هذا تفْسِيرٌ لِقولهِ: {قُمْ اللّيْل إلّا قلِيلا نِصْفهُ أوْ اُنْقُصْ مِنْهُ قلِيلا أوْ زِدْ عليْهِ} كما قدّمْنا.{وطائِفةٌ مِنْ الّذِين معك}: رُوِي أنّهُ لمّا نزلتْ: {يأيُّها الْمُزّمِّلُ قُمْ اللّيْل إلّا قلِيلا} قامُوا حتّى تورّمتْ أقْدامُهُمْ، فخفّف اللّهُ عنْهُمْ.هذا قول عائِشة، وابْنِ عبّاسٍ، لكِنّ عائِشة قالتْ: خفّف اللّهُ عنْهُمْ بِالصّلواتِ الْخمْسِ.وقال ابْنُ عبّاسٍ: بِآخِرِ السُّورةِ، ونُبيِّنُهُ إنْ شاء اللّهُ.المسألة الثّانِيةُ:قولهُ: {واللّهُ يُقدِّرُ اللّيْل والنّهار}؛ يعْنِي يُقدِّرُهُ لِلْعِباداتِ؛ فإِنّ تقْدِير الْخِلْقةِ لا يتعلّقُ بِهِ حُكْمٌ، وإِنّما يرْبِطُ اللّهُ بِهِ ما شاء مِنْ وظائِفِ التّكْلِيفِ.المسألة الثّالِثةُ:قولهُ: {علِم أنْ لنْ تُحْصُوهُ} يعْنِي تُطِيقُوهُ.اعْلمُوا وفّقكُمْ اللّهُ أنّ الْبارِئ تعالى وإِنْ كان لهُ أنْ يحْكُم فِي عِبادِهِ بِما شاء، ويُكلِّفهُمْ فوْق الطّوْقِ، فقدْ تفضّل بِأنْ أخْبر أنّهُ لا يفْعلُ.وما لا يُطاقُ ينْقسِمُ قِسْميْنِ: أحدُهُما ألّا يُطاق جِنْسُهُ أيْ لا تتعلّقُ بِهِ قُدْرةٌ.والثّانِي: أنّ الْقُدْرة لمْ تُخْلقْ لهُ، وإِنْ كان جِنْسُهُ مقْدُورا؛ كتكْلِيفِ الْقائِمِ الْقُعُود أوْ الْقاعِدِ الْقِيام؛ وهذا الضّرْبُ قدْ يُغلّبُ إذا تكرّر بِقِيامِ اللّيْلِ مِنْهُ، فإِنّهُ، وإِنْ كان مِمّا تتعلّقُ بِهِ الْقُدْرةُ، فإِنّهُ يُغلّبُ بِالتّكْرارِ والْمشقّةِ، كغلبةِ خمْسِين صلاةٍ لوْ كانتْ مفْرُوضة، كما أنّ الِاثْنيْنِ والْعِشْرِين ركْعة الْمُوظّفة كُلّ يوْمٍ مِنْ الْفرْضِ والسُّنّةِ تغْلِبُ الْخلْق، فلا يفْعلُونها، وإِنّما يقُومُ بِها الْفُحُولُ فِي الشّرِيعةِ.المسألة الرّابِعةُ:قولهُ: {فتاب عليْكُمْ}؛ أيْ رجع عليْكُمْ بِالْفراغِ الّذِي كُنْتُمْ فِيهِ مِنْ تكْلِيفِها لكُمْ.وهذا يدُلُّ على أنّ آخِر السُّورةِ هِي الّتِي نسختْها، كما روتْ عائِشةُ فِي الصّحِيحِ، كما نقلهُ الْمُفسِّرُون عنْها.المسألة الْخامِسةُ:قولهُ: {فاقْرءُوا ما تيسّر مِنْ القرآن}: فِيهِ قولانِ: أحدُهُما أنّ الْمُراد بِهِ نفْسُ الْقراءة.الثّانِي: أنّ الْمُراد بِهِ الصّلاةُ، عبّر عنْها بِالْقراءة؛ لِأنّها فِيها، كما قال: {وقرآن الْفجْرِ إنّ قرآن الْفجْرِ كان مشْهُودا} وهُو الْأصحُّ؛ لِأنّهُ عنْ الصّلاةِ أخْبر، وإِليْها رجع الْقول.المسألة السّادِسةُ:قولهُ: {علِم أنْ سيكُونُ مِنْكُمْ مرْضى وآخرُون يضْرِبُون فِي الْأرْضِ يبْتغُون مِنْ فضْلِ اللّهِ وآخرُون يُقاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ}: بيّن اللّهُ سبحانهُ عِلّة التّخْفِيفِ بِأنّ الْخلْق مِنْهُمْ الْمرِيضُ، ومِنْهُمْ الْمُسافِرُ فِي طلبِ الرِّزْقِ، ومِنْهُمْ الْغازِي، وهؤُلاءِ يشُقُّ عليْهِمْ الْقِيامُ؛ فخفّف اللّهُ عنْ الْكُلِّ لِأجْلِ هؤُلاءِ.وقدْ بيّنّا حِكْمة الشّرِيعةِ فِي أمْثالِ هذا الْمقْصِدِ.المسألة السّابِعةُ:قولهُ: {فاقْرءُوا ما تيسّر مِنْهُ}: معْناهُ صلُّوا ما أمْكن؛ ولمْ يُفسِّرْهُ.ولِهذا قال قوْمٌ: إنّ فرْض قِيامِ اللّيْلِ بقِي فِي ركْعتيْنِ مِنْ هذِهِ الْآيةِ؛ قالهُ الْبُخارِيُّ، وغيْرُهُ، وعقد باب: «يعْقِدُ الشّيْطانُ على قافِيةِ الرّأْسِ إذا لمْ يُصلِّ بِاللّيْلِ» وذكر فِي حديث آخر: «يعْقِدُ قافِية رأْسِ أحدِكُمْ ثلاث عُقدٍ يضْرِبُ مكان كُلِّ عُقْدةٍ عليْك ليْلٌ طوِيلٌ فارْقُدْ، فإِنْ اسْتيْقظ فذكر اللّه تعالى انْحلّتْ عُقْدةٌ، فإِنْ توضّأ انْحلّتْ عُقْدةٌ، فإِنْ صلّى انْحلّتْ عُقْدةٌ؛ فأصْبح نشِيطا طيِّب النّفْسِ؛ وإِلّا أصْبح خبِيث النّفْسِ كسْلان».وذكر حديث سمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، عنْ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّؤْيا: قال: «أمّا الّذِي يُثْلغُ رأْسُهُ بِالْحجرِ، فإِنّهُ الّذِي يأْخُذُ القرآن فيرْفُضُهُ وينامُ عنْ الصّلاةِ الْمكْتُوبةِ»، وحديث عبْدِ اللّهِ بْنِ مسْعُودٍ قال: ذُكِر عِنْد النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رجُلٌ نام اللّيْل إلى الصّباحِ؛ فقال: ذاك رجُلٌ بال الشّيْطانُ فِي أُذُنِهِ.وهذِهِ كُلُّها أحادِيثُ مُقْتضِيةٌ حمْل مُطْلقِ الصّلاةِ على الْمكْتُوبةِ، فيُحْملُ الْمُطْلقُ على الْمُقيّدِ، لِاحْتِمالِهِ لهُ، وتسْقُطُ الدّعْوى مِمّنْ عيّنهُ لِقِيامِ اللّيْلِ.وفِي الصّحِيحِ واللّفْظُ لِلْبُخارِيِّ: قال عبْدُ اللّهِ بْنُ عُمر: قال لِي رسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «يا عبْد اللّهِ، لا تكُنْ مِثْل فُلانٍ؛ كان يقُومُ اللّيْل فترك قِيام اللّيْلِ».ولوْ كان فرْضا ما أقرّهُ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ولا أخْبر بِمِثْلِ هذا الْخبرِ عنْهُ، بلْ كان يذُمُّهُ غاية الذّمِّ.وفِي الصّحِيحِ عنْ عبْدِ اللّهِ بْنِ عُمر قال: «كان الرّجُلُ فِي حياةِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذا رأى رُؤْيا قصّها على النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فتمنّيْت أنْ أرى رُؤْيا فأقُصُّها على النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وكُنْت غُلاما عزبا شابّا، وكُنْت أنامُ فِي الْمسْجِدِ على عهْدِ رسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فرأيْت فِي النّوْمِ كأنّ ملكيْنِ أخذانِي، فذهبا بِي إلى النّارِ، فإِذا هِي مطْوِيّةٌ كطيِّ الْبِئْرِ، وإِذا لها قرْنانِ، وإِذا فِيها ناسٌ قدْ عرفْتهمْ، فجعلْت أقول: أعُوذُ بِاللّهِ مِنْ النّارِ.قال: ولقِينا ملكٌ آخرُ، فقال لِي: لمْ تُرعْ؛ فقصصْتها على حفْصة، فقصّتْها حفْصةُ على رسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: نِعْم الرّجُلُ عبْدُ اللّهِ، لوْ كان يُصلِّي مِنْ اللّيْلِ.فكان بعْدُ لا ينامُ مِنْ اللّيْلِ إلّا قلِيلا»، ولوْ كان ترْكُ الْقِيامِ معْصِية لما قال لهُ الْملكُ: لمْ تُرعْ واللّهُ أعْلمُ.المسألة الثّامِنةُ:تعلّق كثِيرٌ مِنْ الْفُقهاءِ فِي تعْيِينِ الْقراءة فِي الصّلاةِ بِهذِهِ الْآيةِ، وهِي قولهُ: {فاقْرءُوا ما تيسّر مِنْهُ} فقال قوْمٌ: هِي آيةٌ.وقال قوْمٌ: هِي ثلاثُ آياتٍ؛ لِأنّها أقلُّ سُورةٍ، وبِهِ قال أبُو حنِيفة.وقدْ بيّنّا أنّ الْمُراد بِالْقراءة هاهُنا الصّلاةُ؛ وإِنّما يصِحُّ هذا التّقْدِيرُ، ويُتصوّرُ الْخِلافُ فِي قول النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلرّجُلِ الّذِي علّمهُ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصّلاة، وقال لهُ: «ارْجِعْ فصلِّ؛ فإِنّك لمْ تُصلِّ».وقال لهُ: «اقرأ فاتِحة الْكِتابِ، وما تيسّر معك مِنْ القرآن» وقدْ تكلّمْنا عليْهِ فِي مسائِلِ الْخِلافِ بِما فِيهِ كِفايةٌ لِبابِهِ لِأنّا لوْ قُلْنا: إنّ الْمُراد بِهِ الْقراءة لكان النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قدْ عيّن هذا الْمُبْهم بِقولهِ: «لا صلاة إلّا بِفاتِحةِ الْكِتابِ». خرّجهُ الشّيْخانِ.وكان النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقْرؤُها فِي كُلِّ ركْعةٍ، فقدْ اعْتضد الْقول والْفِعْلُ.جوابٌ آخرُ وذلِك أنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم إنّما قصد واللّهُ أعْلمُ التّخْفِيف عنْ الرّجُلِ، فقال لهُ: «اقرأ ما تيسّر معك مِنْ القرآن» أيْ ما حفِظْت.وقدْ ظنّ الْقاضِي أبُو زيْدٍ الدّبُوسِيُّ فحْلُ الْحنفِيّةِ الْأهْدرُ ومُناضِلُها الْأقْدرُ أنّ قولهُ: {فاقْرءُوا ما تيسّر مِنْهُ} مع زِيادةِ الْفاتِحةِ عليْهِ زِيادة على النّصِّ، والزِّيادةُ على النّصِّ نسْخٌ، ونسْخُ القرآن لا يجُوزُ إلّا بِقرآن مِثْلِهِ، أوْ بِخبرٍ مُتواتِرٍ على الْوجْهِ الّذِي تمهّد فِي أُصُولِ الْفِقْهِ.وأجاب عُلماؤُنا بِأنّ الزِّيادة على النّصِّ لا تكُونُ نسْخا، وقدْ قررْناهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، وهُو مذْهبٌ ضعِيفٌ جِدّا.قال الْقاضِي أبُو زيْدٍ الدّبُوسِيُّ: الصّلاةُ تثْبُتُ بِالتّواتُرِ، فأرْكانُها يجِبُ أنْ تثْبُت بِمِثْلِهِ، فنأْمُرُهُ بِقراءة فاتِحةِ الْكِتابِ، لِخبرِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ولا يُعِيدُ الصّلاة بِترْكِها، لِئلّا تثْبُت الْأرْكانُ بِما لمْ يثْبُتْ بِهِ الْأصْلُ.قُلْنا: هذا باطِلٌ ليْس عليْهِ دلِيلٌ، وإِنّما هُو مُجرّدُ دعْوى.وقدْ اتّفقْنا على ثُبُوتِ أرْكانِ الْبيْعِ بِخبرِ الْواحِدِ، وبِالْقِياسِ؛ وأصْلُ الْبيْعِ ثابِتٌ بِالقرآن، وهذا بعْضُ ما قرّرْناهُ فِي مسائِلِ الْخِلافِ، فلْيُنْظرْ ما بقِي مِنْ الْقول هُنالِك إنْ شاء اللّهُ تعالى.المسألة التّاسِعةُ:قولهُ: {وأقِيمُوا الصّلاة}.المسألة الْعاشِرةُ:قولهُ: {وآتُوا الزّكاة} وقدْ تقدّم بيانُهُما.المسألة الْحادِية عشْرة:قولهُ: {وأقْرِضُوا اللّه قرْضا حسنا} وقدْ تقدّم ذلِك فِي سُورةِ الْبقرةِ. اهـ.
|